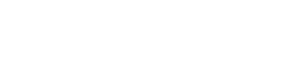الاغترار بنعم الله ونسيان شكرها

عناصر الخطبة
1/ اغترار الإنسان بكرم الله وحلمه عليه 2/ نماذج من نعم الله على العبد وتقصيره في شكرها 3/ أصناف المغرورين بربهم 4/ التناقض بين أقوال بعض المنتسبين للدين وبين أفعالهم
اقتباس
فما أكثر المغرورين بربهم الكريم، وما أكثر فرقهم وأصنافهم التي قل أن ينجو منها عبد من العباد، ولكن يجمعهم أنهم يتصرفون تصرف الآمن من مكر الله، الضامن للجنة والمقام المحمود عند الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إخوة الإسلام: يقول الحق -تبارك وتعالى-: (يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) [الانفطار:6]، ما غرك بربك الكريم؟! ما غرك أيها الإنسان، أيها الماء المهين ما غرك؟! أيها النطفة الحقيرة ما غرك؟! أيها الطين، أيها الصلصال، أيها الحمأ المسنون:
نسي الطين يومًا أنه طيـن *** حـقير فصال تيهًا وعربد
وكـسا الخز جسمه فتباهى*** وحوى المال كيسه فتمردَ
تمرد الطين واختال وعتا وعربد فقال: (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي) [القصص: 78]، وقال: (أَنَا أُحْيِي وَأُمِيت) [البقرة: 258]، وقال: (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ) [الزخرف: 51]، وقال: (مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ) [غافر: 29]، تمرد وعتا فقال: (أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى) [النازعات:24]. فما أحلم الله إذ أمهل كل طين هذا حاله، وكل نطفة ذلك شأنها.
(يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ)، ما غرك به؟! أغرك به ستره عليك وإمهاله لك؟! أم غرك به جهلك وغباؤك؟! حتى أوقعك إبليس في الشرور عن درب الهوى، وفي ملازمة العصيان والتفريط، أهكذا تقابل كرم الكريم؟! أم هكذا تشكر فضل المنعم الحليم؟! أم أنك عميت عن نعم الله عليك وحلمه عنك؟! ألا تجد -أيها الإنسان- في نفسك نعمة أسداها إليك ومنَّ بها عليك؟! أم أنك لا تعرف الله إلا إذا ضاقت بك السبل وأعيتك الحيل؟! (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [النحل: 53 ـ 55]، (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [الحجر:3].
(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) [إبراهيم: 34]، (يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ) [الانفطار: 6، 7]، خلق الله لك لسانًا به تنطق وتتحدث وتعبر، فكان ينبغي أن تشكر ذلك بالذكر والتذكير، وتكرار العلم والتعليم، وإرشاد عباد الله إلى طريق الله، والتأليف بين المسلمين والدفاع عن الدين، وغير ذلك من الخير الذي خُلِق اللسان من أجله، ولكن مع الأسف كان شكرك أن أطلقت لسانك في اللغو والباطل، والكذب والنميمة والفحش والسباب، وكل ساقط من القول، وأقبح من ذلك من ضاد بلسانه الشرع، وصد به عن سبيل الله، واستهزأ بشرع الله، فيا له من ظلوم كفار، ومغرور مخدوع!!
وخلق الله لك عينًا تبصر بها وتهتدي في سيرك وفي عملك، فكان ينبغي أن تشكر المنعم على ذلك، بالنظر بها في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومطالعة الكتب الإسلامية التي تقرب من الله، والنظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، ولكن كان ردك على النعمة بإطلاق بصرك إلى ما حرم الله، وتسخيره في إحراز الشرور والآثام أو ظلم العباد.
وخلق لك أذنًا بها تسمع كلام الخلق، وبها تسمع الأصوات، فتأخذ الحيطة وتنتبه إن كان صوتًا مخيفًا، أو تتلذذ إذا كان صوتًا حبيبًا، فكان ينبغي أن تشكر المنعم بالاستماع إلى آياته وكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن سار على هديه من علماء الأمة ودعاتها، ولكن -ويا للحسرة- كان ردك على المنعم بأن أعرضت عن آيات الله، واستمعت إلى توافه الكلام ولهو الحديث والمعازف والألحان، واللغو والفحش والغيبة وسقط الأقوال، فيا للخيبة ويا للخسران!!
وخلق لك قلبًا يتغذى به البدن والشعور، فيجد الجسم ما يحتاجه من وقود، وتنمو المشاعر والخواطر والأحاسيس، فكان ينبغي أن تشكر المنعم بتعلق القلب به -عز وجل-، وامتلائه بحبه وحب دينه وعباده الصالحين، والانفعال بآياته، والعمل على تنقيته للمسلمين، وتطهيره من الخبائث والأمراض، لكنه ما كان منك إلا أن هام قلبك في أودية الشبهات ومسالك الهوى والضلالات، وطفح بالخواطر المهلكة والإرادات الآثمة، حتى غدا القلب يقوده الشيطان، عياذًا بالله من الهلاك والبوار.
وخلق الله لك عقلاً به تدرك كل ما يحدث حولك، وتتوصل به إلى تدبير شؤونك والسعي في مصالحك، فكان ينبغي أن تشكر صاحب النعمة بتدبر آياته، ومدارسة دينه، وتفهم منهجه، ومناصرة شريعته، وإحباط كيد أعداء الله وشبهاتهم وافتراءاتهم، ولكن كان الرد منك بالتفكير ليل نهار في جمع الدنيا وحطامها، وفي التوصل للشهوات، والاسترسال في الشبهات والضلالات، وفي الإفساد في الأرض وإثارة الشر بين العباد، فهل بعد ذلك من خذلان وضياع؟! وصدق الله -عز وجل- إذ يقول: (وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) [الأحقاف: 26].
وخلق الله لك بطنًا وفرجًا، وجعل فيهما شهوتين عظيمتين تدرك بهما لذة ومتعة، فكان عليك أن تشكر المنعم بالتزام حدوده في الحصول على تلك الشهوات، والصبر إذا ما صعب عليك فعل بعض ما تشتهي في بعض الأوقات، ولكن تجاهل كثير من الناس حدود الله، وانطلقوا مع أمانيهم وشهواتهم فيما يحل ويحرم، ولم يقدموا شكرًا عمليًّا لربهم الحق.
وخلق الله لك يدًا تقوم مقام أجهزة كثيرة لا تعد، ولا تقوم بوظائف اليد بمثل الدقة التي تنجز بها اليد تلك الوظائف، وتأمل كيف جعل الله لك رأس اليد عريضًا -وهو الكف- وقسَّمه خمسة أقسام -وهي الأصابع-، جعلها مختلفة في الطول والقصر، وصفَّها في صفين، بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأصابع البواقي، ولو كانت مجتمعة ومتراكمة لم يحصل تمام الغرض، ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها ولتلتقط بها بعض الأشياء الرفيعة التي لا تحويها الأصابع، وغير ذلك من عجيب صنع الله ونعمته في تلك اليد..
فكان ينبغي للعباد أن يشكروا النعم بهذه اليد بتسخيرها في القتال في سبيله، وإقامة المعروف وإزالة المنكر، وكتابة العلم النافع والكلام المحقق لمصالح العباد، وإعانة العاجز وغير ذلك، ولكن كان رد الإنسان على النعمة باستغلال تلك اليد في نهب ما لا يحل لها أخذه، وفي لمس ما حرم عليها لمسه من مصافحته للأجنبيات، ومسه للعورات المحرمة، وفي البطش بالمظلومين، وفي كتابة الظلم والشرور واللهو والفجور. فعمد إلى ما حرم الله بأن وضع فيها خاتم الذهب، ثم اعتدى بتلك اليد الآثمة على فطرة الله وسنة المرسلين، فغير خلق الله وحلق لحيته، ثم أمسك بها الدخان أو المسكرات، وتناولها متغافلاً عن حق الله في تلك اليد، ثم رسم بها ذوات الأرواح وصورهم، رغم تهديد الله لمن فعل ذلك بأن يكلف يوم القيامة بنفخ الروح فيها، وهكذا مضى الإنسان يحارب الله بنعمه عليه، فيا له من وقح مغرور، وما أحلم الله العلي القدير!!
وخلق الله لك رجلين يحملانك، وبهما تسير في مصالحك وتحصيل مراداتك، وكان ينبغي أن تسعى بهما إلى بيوت الله، وفي الدعوة إلى الله، وإلى مجالس العلم، وإلى الأمر بالمعروف إلى عباد الله لترشدهم، وإلى رحمك لتصلهم، وإلى أحبابك في الله لتزورهم، وإلى الحج والجهاد، وغير ذلك مما خلقت له الجوارح، ولكن بدَّل كثير من الناس نعمة الله كفرًا، فتثاقلت أرجلهم عن حملهم إلى المساجد والجماعات ودروس العلم، وساحات الجهاد، ولكن حملتهم إلى أندية الكرة والمقاهي ونوادي اللهو ومحلات الفحش والفجور، ومجالس اللغو والفساد، وغير ذلك من ساحات تضييع الدين والعمر.
وخلقك الله في أحسن صورة وفي أجمل هيئة، فاختلت بصورتك أو بوسامتك وتكبرت وأعجبت بنفسك وصورتك وهيئتك، واتجهت إلى الشهوات متعاجبًا، وإذا المرأة هي الأخرى بدلاً من شكر ربها بصيانة وجهها وبدنها وستر ذلك عن الناس، إذا بها تبدل نعمة الله كفرًا وتجعل شكرها تكذيبًا وعرضًا لمفاتنها وإبرازًا لصورتها أمام الرجال، بلا مبالاة بشرع ولا عرفان للمنعم الحليم الجليل.
تلك -إخوة الإسلام- بعض نعم الله الظاهرة في الإنسان نفسه، وهي نعم ظاهرة لضعاف العقول والجهال والأغبياء، ولم نذكر شيئًا من النعم التي يعرفها العلماء في هذا الإنسان، ولم نذكر أيضًا نعم الله في الكون على الإنسان، ونعم الله في تسخير مختلف المخلوقات لهذا الإنسان: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) [لقمان: 20]، (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل:18]. تلك النعم كان ينبغي أن تقود الإنسان للاستسلام لربه، والعبودية المطلقة له، والقيام بالتكاليف التي كلفه بها، بل إن الإنسان إذا ما استسلم لربه وقام بما كلفه به واتجه إليه وذكره، فإنه يدرك أن نفس قيامه بالعبودية لله أعظم نعمة، وأجل من جميع النعم السابقة، (بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [الحجرات: 17]، (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا) [المائدة: 3].
فاحمد الله -أيها المسلم- أنه لم يجعلك زنديقًا ولا شيوعيًّا ولا اشتراكيًّا ولا وطنيًّا ولا قوميًّا، ولكن جعلك حنيفًا مسلمًا، (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ) [يونس: 58]، فتلك هي النعمة التي يريد العبد أن يخرج من هذه الدنيا ظافرًا بها؛ ولذا دعا العبد الصالح والنبي الكريم يوسف بن يعقوب -عليهما السلام- ربه قائلاً: (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) [يوسف: 101]. وكان خاتم الأنبياء والمرسلين محمد -صلوات الله وسلامه عليه- يقول في دعائه في صلاة الجنازة: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان".
فيا أيها المسلمون: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعرفوا نعم الله عليكم واحفظوها بالشكر بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم: 7].
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي أطعمنا من جوع، وسقانا من ظمأ، وكسانا من العري، وهدانا من الضلال، وبصرنا من العمى، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، منّ الله على الأمة ببعثه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فما أكثر المغرورين بربهم الكريم، وما أكثر فرقهم وأصنافهم التي قل أن ينجو منها عبد من العباد، ولكن يجمعهم أنهم يتصرفون تصرف الآمن من مكر الله، الضامن للجنة والمقام المحمود عند الله.
فمنهم شاردون بالكلية لا خلق لهم ولا دين، ولا يعرفون سوى أموالهم وبطونهم وفروجهم، ولا يطيب لهم في التزام ظاهر ولا باطن طاهر، وإن خطرت لهم الدار الآخرة كانوا مطمئنين لمكانهم في الجنة، وإذا دعاهم داع إلى ربهم ودينهم تبجحوا، وقالوا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، وافتروا على الدعاة فرية عظيمة، فقالوا: إنهم يدعوننا للتواكل واعتزال الحياة والتسول، فهذا الذي كذب حتى صدق نفسه: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) [الكهف: 5]، فوالله ما دعاكم الدعاة إلى ترك تجاراتكم وأعمالكم، وإنما دعوكم لإقرار حق الله عليكم والإقلاع عن معصيته، فاتقوا النار، وما ترك الصحابة تجارتهم ولا أعمالهم ومع ذلك كانوا دعاة مجاهدين، وتقاة زاهدين، وعلماء صالحين، فلم تمنعهم تجارة من غزو أو جهاد، ولم يمنعهم عمل من علم وطاعة، أو صلاة على وقتها، بل يجمعون المال فينفقونه في سبيل الله ونصرة دعوته وتجهيز الجيوش لغزو الكفرة الفجرة، كانوا وهم يعملون في دنياهم كأنهم يعيشون أبدًا، ويعملون لآخرتهم كأنهم يموتون غدًا، فأين ذلك ممن لا يعرفون بيت الله إلا وهم موتى؟! أو هم محاربون لأهل المساجد أو مخادعون لنفوسهم في المناسبات والموالد المبتدعة لادعاء سمت الدين مع إفلاسهم منه ظاهرًا وباطنًا.
ومن المغرورين: قوم عوَّلوا على حسن خلقهم مع الناس، وابتعادهم عن الظلم، وفرطوا في تقييد ظاهرهم بالشرع، وقصروا في كثير من الطاعات، ويقولون: سيغفر لنا، وكأن ما شرعه الله ورسوله لإصلاح الظاهر عبث ولعب، فاستدرجهم الشيطان إلى مشابهة الكفار في كثير من أمورهم؛ لينتهي بهم إلى مشابهتهم في الباطن أيضًا، وحسّن لهم مسلكَهم علماءُ السوء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا، ويحاربون كل مظهر للإسلام أو الالتزام الجاد، حتى ترضى عنهم آلهتهم، وتبقى لهم كراسيهم.
ومن المغرورين: قوم استداموا لظواهر الأعمال والعبادات، وفرطوا في إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم ومعرفة عيوبهم، حتى أصبح كلامهم وحديثهم في إصلاح الظواهر، وينكرون على غيرهم أمورًا تلبسوا هم بأشد ضررًا وقبحًا منها.
ومن المغرورين أيضًا: فريق لم يقصروا في إصلاح باطنهم، ولم يقصروا كذلك في إصلاح ظاهرهم، لكنهم مع ذلك اختاروا العزلة وركنوا للدعة والراحة، ولم يقوموا بنصرة دين الله وإقامة الحق والعدل ونشر الهدى، فصاروا في المجتمع كموتى لا أثر لهم ولا حياة، وما هكذا كان شأن المسلمين الأوائل، بل هي عندهم قضية واحدة لا انفصال فيها: الإيمان بدين الله ونصرته، والحياة من أجله، والبذل والتضحية في سبيله.
وفريق أخير من المغرورين أعجبوا بأنفسهم لقيامهم بالوعظ والتذكير، وغرّهم ثناء الناس، فصاروا لا يقتلون مرضًا ولا يراجعون في أنفسهم عيبًا، حتى إنهم احتموا بالوعظ والتذكير، ففرطوا في حدود الله، واجترؤوا على معاصي الله، وخلت قلوبهم من توقير الله ومراقبته، وليسمع كل واحد منا قول ابن السماك -رحمه الله-: كم من مذكر بالله ناس لله، وكم من مخوف بالله جريء على الله، وكم من مقرِّب إلى الله بعيد عن الله، وكم من داع إلى الله فارُّ من الله، وكم من تالٍ لكتاب الله منسلخ عن آيات الله: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) [النساء: 108].
إذا ما قـال لـي ربـي *** أمـا استـحييت تعصيني
وتخفي الذنب من خلقـي *** وبــالعصـيان تـأتيني
فما قـولـي لـه لـما *** يـعاتبـني ويقـصـيني
واسمعوا إلى قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إذ يقول: من نصب نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه، ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم.
وقال الشعبي -رحمه الله-: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار، فيقولون لهم: ما أدخلكم النار وإنما أُدخِلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟! فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله، وننهى عن الشر ونفعله.
فيا ويح هذه الأمة من ثلاث آيات رادعة لكل مذكِّر، مخوفة لكل واعظ أو داع أو إمام؛ قوله تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) [البقرة: 44]، وقوله -عز وجل-: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ) [هود: 88]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [الصف: 2، 3].
وفريق أخير من المغرورين، أحرزوا صلاح الظاهر والباطن، ونشطوا لدينهم والدعوة إليه ونصرته، ولكن غرورهم بدوام حالهم على ما هو عليه فلا يخافون الخاتمة، ولا يفكرون فيها، مع أن أبواب الفتن لا تنحصر، والشهوات والمغريات شديدة وكثيرة، وليس أحد أكبر من الذنب ولا معصوم، مهما كان شريفًا أو عالمًا أو عابدًا. والله أعلم بالخواتيم.
قال حاتم الأصم -رحمه الله-: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء: الأول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني: حين خُلق في ظلمات ثلاث، فنادى الملك بالشقاوة والسعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث: ذكر هول المطلع، يعني مطلع الروح، فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتًا، فلا يدري أي الطريقين يسلك به.
وكان سفيان يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت.
وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيته ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟!
وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول في دعائه: "يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك"، فقيل له: يا نبي الله: آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟! فقال: "نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن -عز وجل- يقلبها كيف يشاء".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة".
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: والأول نادر، والثاني كثير، فإن من رحمته تعالى أن تحول إنسان من الشر إلى الخير أكثر من ارتداده عن الخير إلى الشر، وإنما ينجو العبد من سوء الخاتمة بكثرة تفكره في ذلك وخوفه منها، وباهتمامه الشديد بعيوب نفسه ودسائسها الخفية التي توجب سوء الخاتمة عند الموت، وباتقاء الذنوب والمعاصي والأمن من مكر الله.
قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة: لا إله إلا الله. فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول. ومات على ذلك، قال: فسألت عنه، فإذا هو مدمن خمر، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب، فإنها هي التي أوقعته.
اللهم اجعل خير أعمالنا يوم لقائك، اللهم اجعل عملنا كله لك خالصًا، ولا تجعل فيه نصيبًا لسواك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، ورحمة لا تلهينا، اللهم تب على التائبين، واعف عن العصاة المذنبين، وانصر عبادك المجاهدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.